نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أوروبا من الحليف إلى الخصم.. كيف يفكر ترامب؟ - عرب فايف, اليوم السبت 26 أبريل 2025 11:14 مساءً
- سيد البيت الأبيض صعد المواجهات التجارية مع بكين ووصف شركاءه الأوربيين بـ «العدو».. وفتح أبواب الحوار لإيران وروسيا
- تصدعات خطيرة في ركائز الديمقراطية الأمريكية.. رقابة على الآراء السياسية بالجامعات.. عمليات فصل واسعة وملاحقة للخصوم.. عداء للإعلام وتجسس على الموظفين
منذ عودته إلى البيت الأبيض، رئيساً لدورة رئاسية ثانية في يناير الماضى، يواصل دونالد ترامب رسم مسار السياسة الخارجية الأمريكية بطرق مثيرة للجدل، وفي محيط دولي يشهد تحولات جذرية، تبدو سياساته محكومة بتكتيك الصفقات والضغوط، ما يطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقات الدولية في ظل قيادته.
من النزاع التجاري المتصاعد مع الصين، إلى العلاقات المتوترة مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا، ومن سياسة "الجدران" التي تستهدف الجيران إلى الانفتاح على روسيا وإيران، تُظهر إدارة ترامب الحالية ملامح تكرار سياساته السابقة بل وتوسيعها في بعض المجالات.
ومن الواضح أن سياسة ترامب تتمحور حول المصلحة الوطنية الضيقة، ما يجعلها تثير القلق والدهشة في آن واحد، ويجعل العالم يقف على حافة ترقب، مستعدًا لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر بشكل عميق على النظام الدولي برمته.
تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في أقل من 3 أشهر، حيث وصف ترامب، الاتحاد الأوروبي بأنه "عدو" في بعض المناسبات، وانتقد دول الناتو لعدم مساهمتها المالية الكافية في الدفاع المشترك، كما فرض رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية.
ورد قادة الاتحاد الأوروبي بمواقف حازمة، داعين الرئيس الأمريكي إلى تفادي حرب تجارية "لا رابح" فيها، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مارس الماضي لقادة دول وحكومات الاتحاد في بروكسل "إذا تعرضنا لهجوم حول المسائل التجارية، فسيكون على أوروبا، كقوة ثابتة على موقفها، أن تفرض احترامها وبالتالي أن ترد".
واعتمدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نبرة مماثلة تنم عن حزم، فأكدت "نحن بحاجة إلى أمريكا وأمريكا بحاجة إليناً"، مؤكدة أن "الرسوم الجمركية تزيد التكاليف، وهي ليست في صالح الوظائف وليست في صالح المستهلكين، هذا واضح".
وبحسب تقرير أعدته "فايننشال تايمز" يتفق العديد من القادة الأوروبيين على أن واشنطن في عهد ترامب تشكل تهديداً، مع أن قلة منهم يصرحون بذلك علناً لأسباب دبلوماسية، فالقادة الأوروبيون يدركون، على نحوٍ مقلق، كيف جعلهم التحالف عبر الأطلسي، الذي دخل عقده الثامن، يعتمدون بشكل كبير على الدعم العسكري الأمريكي، حيث إن المشكلة لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تكمن أساساً في الاعتماد على التكنولوجيا والأسلحة الأمريكية، وهو الأمر الأكثر خطورة في هذا الموضوع.
وحالياً، ينتهج القادة الأوروبيون سياسة ذات مسارين، فهم يعملون على تأجيل قطع الدعم العسكري الأمريكي عن أوروبا عبر شراء الوقت لأطول فترة ممكنة، مع الاستعداد لتلك اللحظة بأسرع وقت من خلال تفعيل العمل على ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الدفاع الأوروبي المشترك، الدين الأوروبي المشترك، ورأب الصدع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبعد قرار إدارة ترامب بقطع تدفقات المعلومات الاستخباراتية والأسلحة عن أوكرانيا، أدرك الأوروبيون حجم المتاعب التي يواجهها الأوكرانيون، وكان هذا التصرف الأمريكي وراء القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بالسماح بجمع 150 مليار يورو، لإنفاقها على صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن يتركز الإنفاق الجديد على المجالات التي تعتمد فيها الدول الأوروبية بشكل خاص على أميركا، مثل الدفاع الجوي.
وما يعزز التوجه الجديد للقادة الأوروبيين هو التحوّل العميق في مزاج الرأي العام الأوروبي، حيث أظهر استطلاع مؤخرا أن 78% من البريطانيين يعتبرون ترامب تهديداً للمملكة المتحدة، ويتفق معهم حوالي 74% من الألمان، و69% من الفرنسيين.
الصين: حرب تجارية وتوترات متصاعدة
"سنقاتل حتى النهاية!".. بهذه العبارة أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "لين جيان"، في 8 أبريل، استعداد بلاده لمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة إذا قررت المضي قدمًا في الحرب التجارية.
جاء هذا التصعيد بعد أن فرضت الصين، في 4 أبريل، قيودًا اقتصادية شاملة على الولايات المتحدة، وذلك ردًا على قرار دونالد ترامب في 2 أبريل بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على غالبية الواردات الصينية.
ومع تصاعد وتيرة الردود المتبادلة، أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض رسومًا بنسبة 125% على السلع الأميركية، ردًا على حزمة تعريفات جمركية جديدة أقرتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ، لترفع نسبة التعريفات الإضافية على الواردات الصينية إلى 145%.
ورغم كثافة التصعيد، يواصل دونالد ترامب استخدام الغموض كوسيلة تفاوض، وهو أسلوب يعتبره مؤيدوه جزءًا من قدرته على عقد الصفقات. فلا أحد يعلم على وجه التحديد إن كان يهدف فعلاً إلى قطع العلاقات التجارية مع الصين، أو إعادة هيكلة النظام التجاري العالمي، أو أن الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط لتحقيق اتفاقات تخدم مصالح واشنطن، كما حدث في اتفاق 2020.
لكن المؤكد أن التصعيد السريع أوصل الحرب التجارية إلى مرحلة يصعب معها التوصل إلى اتفاق في المدى المنظور، رغم الخسائر الاقتصادية المتوقعة لكلا الطرفين، إذ بات الجانبان عالقين في مسار تصادمي مرشح لمزيد من التوتر.
وإذا استُنفدت أداة الرسوم الجمركية، فقد يتجه الطرفان إلى استخدام أدوات ضغط جديدة في إطار صراع جيوسياسي يتجاوز مجرد التجارة.
ويبرر ترامب هذا التصعيد باتهام الصين ودول آسيوية أخرى بممارسات تضر بالاقتصاد الأميركي، كإغراق الأسواق بمنتجات رخيصة، والتلاعب بالعملة، وسرقة الملكية الفكرية، وتقديم دعم غير عادل للشركات المحلية.
ورغم تعدد المبررات، فإن ترامب يضمر موقفًا شخصيًا من الصين، إذ يعتقد أنها ساهمت في خسارته انتخابات 2020 بسبب ما يعتبره تقصيرًا منها في الشفافية خلال أزمة جائحة كورونا.
في بداية الحرب التجارية، حين فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على 13% من واردات الصين، جاء الرد الصيني آنذاك هادئًا ودبلوماسيًا، ما مهد الطريق للتوصل إلى اتفاق لتقليص العجز في الميزان التجاري، لكن الردود الصينية اليوم باتت أكثر حدة، في إشارة إلى تبني بكين إستراتيجية جديدة تقوم على مبدأ الندية مع واشنطن، ويبدو أنها استعدت مسبقًا لهذا السيناريو.
فإلى جانب فرض رسوم مضادة، اتخذت الصين خطوات أشد، منها فرض قيود على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة ومركّبات تدخل في تصنيع الأسلحة والمركبات الكهربائية، فضلًا عن إدراج 16 شركة أميركية، معظمها دفاعية، ضمن قوائم مراقبة الصادرات، وإضافة 11 شركة أخرى إلى "قائمة الكيانات غير الموثوق بها"، ومنعها من الاستثمار أو التصدير داخل الصين.
ويبدو أن صناع القرار في بكين يراهنون على أن الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالولايات المتحدة ستكون كافية لدفعها نحو التراجع. فرغم أن الصين استوردت في عام 2024 بضائع أميركية بقيمة 165 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 525 مليار دولار، فإنها مستعدة لتحمل الخسائر ضمن سياسة إثبات الذات ورفض الضغوط.
وتُعد الصين المورد الأساسي لأكثر من ثلث واردات الولايات المتحدة، وتوفر أكثر من 70% من احتياجاتها من بعض السلع، وفقًا لتقديرات بنك "غولدمان ساكس"، ما يعني أن استمرار الحرب التجارية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع بنسبة تتجاوز 100%.
وفي تقرير صدر في أكتوبر 2024، حذرت "مجموعة الأزمات الدولية" من أن خطر التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة والصين سيظل قائمًا ما لم يتمكن الطرفان من إدارة خلافاتهما الإستراتيجية بواقعية وعقلانية.
الجيران: سياسة الجدران والعقوبات
منذ عودته إلى البيت الأبيض، بدا واضحًا أن ترامب لم يتخلَّ عن السياسات الصلبة التي اتبعها خلال ولايته الأولى، بل أعاد تفعيل أدوات الضغط ذاتها، مع تعديلات تتناسب مع المتغيرات الدولية والمحلية، وعلى رأس هذه السياسات تأتي "سياسة الجدران والعقوبات"، كنهج متكرر في التعامل مع الجيران، خصوصًا المكسيك.
ولطالما كان الجدار الحدودي مع المكسيك رمزًا لسياسة ترامب في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وفي ولايته الأولى، بدأ ببناء أجزاء من هذا الجدار وسط وعود بحماية الحدود وتعزيز السيادة الوطنية، واليوم، في ولايته الثانية، عاد ترامب ليؤكد عزمه على استكمال ما بدأه، مع توسيع المشروع ليشمل تقنيات مراقبة أكثر تطورًا، واستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد محاولات التسلل عبر الحدود.
ويصف أنصاره هذا المشروع بأنه ضرورة أمنية، بينما يرى منتقدوه أنه استثمار سياسي أكثر منه أمني، يهدف إلى تأكيد الخطاب الشعبوي بشأن "استعادة السيطرة" على الحدود.
كما أعاد ترامب تفعيل أدوات العقوبات الاقتصادية، ليس فقط ضد الخصوم البعيدين، بل حتى تجاه الجيران القريبين. ففي ولايته الأولى، لوّح بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية لإجبارها على الحد من الهجرة. واليوم، يكرر نفس النهج، ولكن مع نبرة أشد وتصعيد أكبر.
وقد هدد مؤخرًا بفرض تعريفات جمركية تصاعدية على المكسيك ما لم تُظهر التزامًا أكثر صرامة تجاه ضبط حدودها الجنوبية ومنع تدفق المهاجرين نحو الأراضي الأميركية، وكذلك، أثار مسألة إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية مع كندا والمكسيك، في محاولة لاستعادة ما يصفه بـ"عدالة التبادل التجاري".
إيران: من الضغط الأقصى إلى الحوار المشروط
وفي تطور غير متوقع، عاد ترامب إلى طاولة المفاوضات مع إيران بعد سنوات من التوترات والتهديدات المتبادلة، ففي مارس 2025، أرسل ترامب رسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مقترحًا استئناف المحادثات النووية. ورغم الردود الأولية المتحفظة من طهران، بدأت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة في مسقط، عمان، في 12 أبريل، تلتها جولة ثانية في روما في 19 أبريل.
وتدار المفاوضات بشكل غير مباشر، حيث يتواصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر وسطاء من سلطنة عمان، وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد يُلزم إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، مع الحفاظ على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وتطالب إيران بضمانات قوية لضمان التزام الولايات المتحدة بأي اتفاق مستقبلي، خاصة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي السابق في 2018، ومن بين هذه الضمانات، تطالب طهران بتوقيع الاتفاق كمعاهدة من قبل الكونغرس الأمريكي أو فرض عقوبات مالية على واشنطن في حال انسحابها مرة أخرى.
وداخل إدارة ترامب، كان هناك انقسام واضح حول كيفية التعامل مع إيران، ففي حين يدعم نائب الرئيس جيه دي فانس المسار الدبلوماسي، يُفضل مستشار الأمن القومي مايك والتز ووزير الخارجية ماركو روبيو اتخاذ موقف أكثر تشددًا، مشككين في نوايا إيران.
وتستمر المحادثات الفنية بين الخبراء في عمان، مع جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة، ويأمل الطرفان في التوصل إلى اتفاق خلال 60 يومًا، وهو الموعد النهائي الذي حدده ترامب، محذرًا من "عواقب عسكرية" إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس.
روسيا: علاقات معقدة نحو الانفتاح
تُعدّ علاقة ترامب بروسيا، وتحديدًا بالرئيس فلاديمير بوتين، واحدة من أكثر العلاقات الدولية إثارةً للجدل في 2025، فهي علاقة تتأرجح بين التعاون السري والتنافس العلني، مما يثير العديد من التساؤلات حول توجهات السياسة الخارجية الأمريكية.
فقد فوجئت الأوساط الاقتصادية العالمية بامتناع ترامب عن فرض رسوم جمركية على روسيا، في الوقت الذي فرض فيه رسومًا على العمليات التجارية مع أوكرانيا – الحليف التقليدي للولايات المتحدة – بالإضافة إلى رسوم أخرى على الاتحاد الأوروبي وعدة دول حول العالم.
وفي نوفمبر 2024، تناقلت تقارير إعلامية أن ترامب حث بوتين خلال مكالمة هاتفية على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، إلا أن الكرملين سارع إلى نفي حدوث هذه المكالمة، واصفًا تلك التقارير بأنها "خيال محض".
ومنذ عودة ترامب، شهد الدعم الأمريكي لأوكرانيا تراجعًا ملحوظًا، مما دفع المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى إلى سد هذا الفراغ بتقديم مساعدات مالية وعسكرية مكثفة، وفي المقابل، يواصل ترامب تصريحاته المثيرة، متعهدًا بإنهاء الحرب.
أما على الجانب الروسي، فقد صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تتطور بشكل جيد جدًا"، مشيرًا إلى وجود تبادل نشط للزيارات بين مبعوثي البلدين.
وأوضح بيسكوف أن هناك قنوات مفتوحة للتواصل بين الأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية في كلا البلدين، في إطار جهود لتطبيع العلاقات الثنائية.
وفي سياق اقتصادي لافت، كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها، أن روسيا، ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، تمكنت من تصدير بضائع إلى الولايات المتحدة بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
أزمات داخلية تتفاقم
منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بدأت البلاد تشهد هزّات داخلية أثرت في مؤسساتها الديمقراطية، وفقًا لتقارير متزايدة من مراكز أبحاث مرموقة، من بينها معهد بروكينز في واشنطن، الذي حذر من "تصدعات خطيرة في ركائز الديمقراطية الأمريكية"، وسط هجمات متتالية على هذه الأسس من قبل الإدارة الجديدة.
أحدث فصول هذا التصعيد تمثّل في هجوم ترامب على جامعة هارفارد، حيث وصفها على منصته "تروث سوشيال" بأنها "أضحوكة تنشر الكراهية والغباء"، مطالبًا بوقف تمويلها الفيدرالي، وذلك على خلفية ما وصفه البيت الأبيض بتراخي الجامعات، خاصة هارفارد، في التعامل مع احتجاجات داعمة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.
لكن الخلاف أعمق من ذلك، إذ ترى إدارة ترامب أن مؤسسات النخبة الأكاديمية تميل إلى الفكر اليساري، ما دفعها إلى التهديد بفرض رقابة على الآراء السياسية داخل الجامعات، ومطالبتها بتقديم بيانات مفصلة عن القبول الطلابي، فيما رفض رئيس الجامعة، آلان غاربر، هذه التدخلات، محذرًا من تهديد واضح لاستقلالية التعليم العالي وحرية البحث المكفولة دستوريًا.
وتواجه سيادة القانون تحديات غير مسبوقة، مع تجاهل الإدارة لأحكام قضائية، كما يتعرض قضاة فدراليون للتهديد والتشهير العلني إذا عارضوا سياسات الترحيل، ووصل الأمر إلى حد تهديد بعضهم بالعزل، في حين عُيّن قضاة موالون لترامب.
أيضًا، وُجّهت وزارة العدل إلى ملاحقة خصوم الرئيس، وشهدت الأسابيع الأولى من رئاسته عمليات فصل واسعة شملت مدّعين فدراليين من عهد جو بايدن، وتم تعيين محامين مقرّبين من ترامب في مناصب عليا، أحدهم أصبح نائبًا للمدعي العام. كما أصدر ترامب عفوًا عن قرابة 1600 شخص من المتورطين في اقتحام الكابيتول، وعيّن بام بوندي، المعروفة بولائها له، في وزارة العدل.
ولم يخفِ ترامب عداءه للإعلام الناقد، حيث وصف كبرى القنوات مثل CNN وMSNBC بأنها "فاسدة وغير قانونية"، واتهمها بتغطية سلبية ضده بنسبة 97.6%، معتبرًا إياها امتدادًا للحزب الديمقراطي. وهدد سابقًا بإلغاء تراخيص الإعلام غير الموالي.
وقد ألغت الإدارة تمويل وسائل إعلام دولية مثل "صوت أمريكا" و"راديو ليبرتي"، واقتربت من إغلاقهما. كذلك سُحب اعتماد وكالة "أسوشييتد برس" من البيت الأبيض، بعد رفضها استخدام مصطلح "خليج أمريكا" بدلاً من "خليج المكسيك"، رغم أن القضاء اعتبر هذا القرار غير قانوني، إلا أن الإدارة تجاهلته.
وفي خطاب أمام الكونجرس، أعلن ترامب أن "عهد البيروقراطيين غير المنتخبين قد انتهى"، وكلف مستشاره غير المنتخب إيلون ماسك بإعادة هيكلة الإدارات الفيدرالية، وتحت هذه السياسة، شُرع في تسريح واسع للموظفين من وزارات وهيئات تشمل الضرائب، البيئة، الصحة، والدفاع.
وتم وقف برامج التنوع والاندماج، وخُفّض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية، وتم تقليص اللوائح البيئية، في توجه وصفه البعض بـ"الهجوم المنهجي على مؤسسات الدولة".
وفي تطور مثير للجدل، يُتهم مسؤولو وزارة التعليم العالي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتجسس على الموظفين الحكوميين، ورصد تعليقاتهم السياسية. ويخشى منتقدون أن يكون الهدف هو فصل غير الموالين لترامب، و"تطهير" جهاز الدولة من الأصوات المعارضة.


















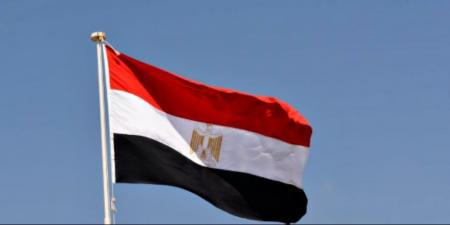
0 تعليق